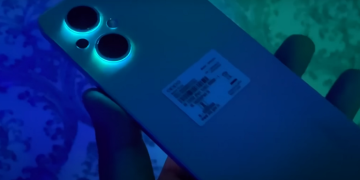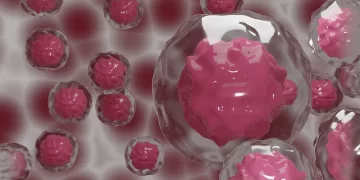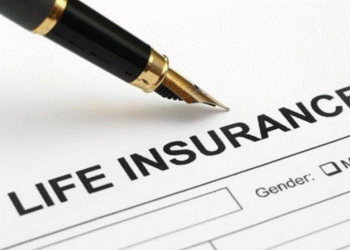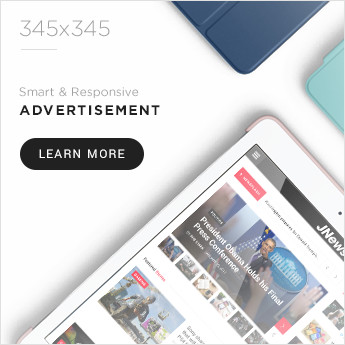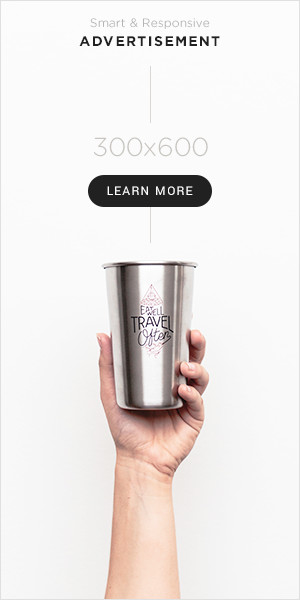وأثار غضب الملك بسبب “تكاسل” العلماء في مواجهة التطرف الذي تمثله “داعش“، نقاشاً طويلاً في السعودية، وتجلّى ذلك في مواكبة ناشطين سعوديين اللقاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسموا في تفسيراتهم حوله وردود أفعالهم تجاهه. فقد رأى بعضهم أن “داعش” بالفعل يمثّل خطراً حقيقياً، واعترفوا أن المشايخ لم يقوموا بدورهم الفكري والعقائدي بالفعل كما يجب في مواجهة التنظيم.
ولا يتوافق هذا الرأي مع رأي فريق آخر، الذي لا ينفي التهديد الذي يمثله “داعش“، ولكنه في الوقت عينه لا يعتبر أن العلماء تقاعسوا عن دورهم في هذا الاتجاه، خصوصاً مَن هم خارج السلطة. ويعتبر هذا الطرف أن الملك السعودي ينتقد فئة محدّدة.
ويجنح بعضهم إلى نفي وجود تهديد حقيقي يمثله “داعش” على السعودية، ويعتبرون أن الحديث في هذا الأمر يحتمل تضخيماً ومبالغة.
أما المعنيون من المشايخ أو ما يطلق عليهم “العلماء” في السعودية، فليسوا طيفاً واحداً كما يظنّ كثر خارج المملكة. ويتوزّع العلماء إلى فريقين: الأول داخل الدولة، وفريق خارجها، فمَن كان يتحدث إليهم الملك وكانوا مسترخين إلى جانبه، هم العلماء المنضوون تحت مظلّة الدولة، كالمفتي عبد العزيز عبد الله الشيخ، ومجموعة من أعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ التقليديين ممّن يتقلّدون مناصب مختلفة في الدولة ومؤسساتها، أما الباقي فليسوا سوى العلماء المُنتَقَدون، أي العلماء غير المحسوبين على الدولة.
ولفت الكاتب السعودي، خالد الدخيل، إلى أن “ما حدث في اللقاء ليس سوى تعبيرٍ عن الضعف والتكلّس الذي وصلت إليه المؤسسة الدينية الرسمية في علاقتها مع الدولة السعودية، وتنبع أهمية حديث الملك من أنه انطوى، من دون أن يكون مقصوداً، على ملمح لما وصل إليه تاريخ المؤسسة الدينية الرسمية”. ويضيف الدخيل: “تبدو علاقة المؤسسة بالدولة في هذه اللحظة غير متكافئة، فهذه المؤسسة لا تعاني من الكسل، وإنما من حال ضعف وتكلّس لم تعرفها من قبل في تاريخها”.
ولطالما كانت علاقة المؤسسة الدينية السعودية مع الدولة بمثابة الشريك في الحكم والإدارة وتقاسم السلطة، هذا الأمر الذي نشأت عليه الدولة قبل 270 عاماً تقريباً ما بين الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود. العلاقة التي مرّت بتحوّلات كثيرة، طالت معادلة “الشيخ/ الأمير” كمتقابلات في السلطة والنفوذ والقوة.
فهل نفهم أيضاً من هذا المشهد، الذي على ما يبدو أنه يحدث للمرة الأولى وبشكل علني، في نقد العلماء وأمام عدسات التصوير وعلى مرأى من الجميع، أن السعودية بشكل عام تتعرّض لحملات غربية كبيرة؟ ضغوط قد تعيد إلى الذاكرة ما حصل بعد أحداث سبتمبر/ أيلول 2001، من خلال اتهام المملكة بدعم تنظيمات متطرفة؟
في السياق، كتب سايمون هندرسون مقالاً في “فورين بوليسي”، بعنوان: “السعودية تدعم داعش“، يتهم فيه الرياض بدعم “الدولة الإسلامية” في العراق، تحدياً لإيران وفي سبيل تحقيق ما سمّاه “نكسة استراتيجية” للأخيرة، وهو ما لم تنجح فيه السعودية في الحالة السورية، على حد ما كتبه.
كلام دفع بالسفير السعودي في لندن، الأمير محمد بن نواف، إلى الردّ على مقال مشابه، كتبه ريتشارد تايلور في “الغارديان”، قال فيه: “أقول، وبكل وضوح: إن الحكومة السعودية لا تدعم ولا تموّل القَتَلة الذين تجمعوا تحت راية ما يُعرف بالدولة الإسلامية، وأيديولوجيتهم ليست من النوع الذي نعترف به أو تعترف به الغالبية الساحقة من المسلمين حول العالم، سواء السنّة أو الشيعة. نحن نقاتل التطرّف داخل حدودنا يومياً، بل كل ساعة”.
وما يمكن استنتاجه هو أن ضعف المؤسسة الدينية، وخوف وتوتر الدولة السعودية بسبب وجود “داعش” على الحدود، يساهم في فهم غضب الملك، وطلبه من العلماء التحرك الفكري ضد “داعش“، خوفاً من وجود حاضنة شعبية للتنظيم، خصوصاً في شمال السعودية، حيث تستشعر الحكومة تهديد التنظيم بصورة أكبر.
وتتساءل أوساط مراقبة، هل أن الغضب على العلماء يشكل محاولة جادة للتفكير بطريقة مختلفة داخل البيت الملكي السعودي، تختلف عمّا درجت عليه الدولة في أعقاب الحوادث الكبرى منذ التأسيس، أي طريقة إدارة المشاكل وليس حلّها، والتخفيف من عوارضها وليس علاجها والبحث في أسبابها الحقيقية والخروج منها؟
هذه التساؤلات تجد جذورها في شعور عام بأن المؤسسة الدينية قد هرمت، ولم تعد قادرة على إقناع الناس. كما أن التفكير بمجابهة “داعش” بالفتوى، لم يخرج عن الإطار التقليدي للتعاطي مع ظاهرة كهذه.