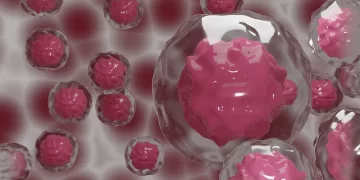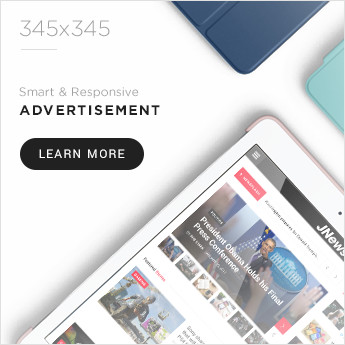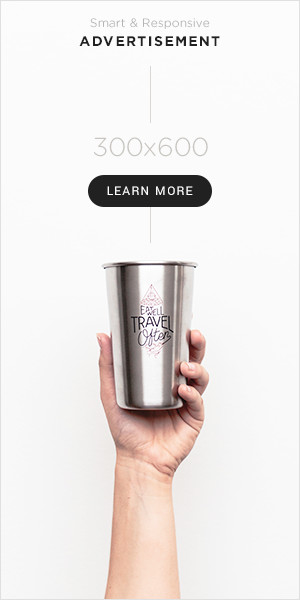أشعل الرئيس الأميركي باراك
أوباما حالة من الجدل داخل الولايات المتحدة عندما قال قبل أيام إن الاستخبارات
الأميركية قللت من الخطر الذي يشكله تنظيم «داعش» واستخفت بنشاطه، وفي المقابل
بالغت في تقدير قوة الجيش العراقي، هذا الاعتراف بخطأ التقدير الاستخباراتي الذي
يبنى عليه القرار السياسي أثار موجة من الانتقادات لأن أوباما أوحى بكلامه بأنه
يلقي باللائمة والمسؤولية على أجهزة المخابرات من دون أن يعترف بأخطائه التي كان
منها الانسحاب الشامل من العراق من دون ترك قوة أميركية فيه، ودعم نوري المالكي
الذي يلومه اليوم لإهداره الفرص وتركيزه على قاعدته الشيعية وإهماله الأكراد
والسنة، وإدارة الظهر للأزمة السورية التي تحولت مركز جذب لكل صراعات المنطقة
وجهاديي العالم.
وأثار قرار أوباما بخطأ التقدير لقوة «داعش»، وفي مرحلة مبكرة من الحرب ضدها،
القلق أكثر مما أثار الارتياح وفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بالوضع في سورية وما
إذا كان الأمر سيقتصر على سوء تقدير جديد أم يتجاوزه الى غياب الاستراتيجية وعدم
وضوح الرؤية، ويضاف ذلك الى التساؤل المتعلق بعدم مشاركة الدول الأوروبية في الحرب
على «داعش» في سورية واقتصار مشاركتها على توجيه ضربات في العراق، والتساؤل الآخر
المتعلق ببنك الأهداف في سورية إذا صح أن أميركا لا تملك وجودا استخباراتيا قويا
على الأرض، وتساؤل ثالث يتعلق بموقف تركيا ومسارعتها الى اقتناص الفرصة لتحصيل واقع
جديد حدودي من خارج الخطط الأميركية.
ثمة جدل آخر يدور حول جدوى الضربات الجوية وقدرتها، من دون قوات واجتياحات برية،
على إحداث تغيير جذري على الأرض بعد الموجة الأولى التي نجحت «داعش» في امتصاصها
والتي لم تغير كثيرا في المعطيات الميدانية، بما في ذلك استمرار «داعش» في وضعية
هجومية ضد الأكراد، ومع اتجاه هذا التنظيم الى إعادة هيكلة قواته وتوزيعها الى
مجموعات صغيرة تتغلغل في المدن الكبيرة وتسيطر عليها، وإذا كان إضعاف قدرات «داعش»
التي تسيطر على أراض تعادل مساحة الأردن، يجب أن تتم بموازاته تقوية لقدرات
المعارضة المعتدلة، فإن هذه المعارضة المطلوب منها أن تقاتل «داعش» والأسد معا
عملية تسليحها وتدريبها تتطلب شهورا وسنوات، وهذا يعني أن الحرب طويلة وستمتد حتى
بعد خروج أوباما من البيت الأبيض.
وإذا كان إضعاف قدرات «داعش» شرط ضروري من شروط الوصول الى الحل السياسي الذي
يريد الجميع أن يراه في سورية، فإن الشرط الآخر الذي يطرحه الأميركيون وحلفاؤهم هو
إضعاف الأسد من منطلق أن محاربة «داعش» ستكون أسهل إذا تم عزله، وفتح الباب للتنسيق
بين الحكومة السورية الجديدة والمعارضة الرئيسية، وأن تحقيق تقدم ضد الدولة
الإسلامية يتطلب ذهاب الأسد مثلما تطلب الأمر في العراق ذهاب المالكي.
وإذا كان أوباما يقر ولو بشكل ملتبس بأن توجيه ضربة قاضية إلى سرطان «الدولة
الإسلامية» هو رهن عملية انتقال سياسية غير إقصائية في سورية، يبدو أنه لا يملك
إستراتيجية لبلوغ المأرب هذا، وقال مخططو الحرب في إدارته أمام الكونغرس انهم لم
يعدوا لتوسيع الضربات في سورية توسيعا يطاول قوات الأسد، ولو هاجمت فرق المعارضين
التي يعول عليها أوباما في محاربة «الدولة الإسلامية»، ووراء تردد الرئيس الأميركي
أسباب معقولة، فالتعامل مع الأسد عسير، اذ ان الهجمات العسكرية تقتضي تصعيد الحملة
الجوية تصعيدا يعتد به.
والتحرك ضد الأسد يترتب عليه نزاع أو خلاف مع إيران
وروسيا ـ وهما، إلى اليوم، لم تعرقلا الحرب على «داعش» ـ ومع الحكومة العراقية التي
لم تتراجع عن دعم نظام دمشق. لكن تجاهل الأسد يؤدي الى الأسوأ. فالنظام والناطقون
باسمه يحتفون بالغارات الأميركية ويسعون إلى تصوير الولايات المتحدة على أنها حليف
الأمر الواقع، في وقت يتظاهر السوريون في مناطق المعارضة ضد الضربات الأميركية،
والجيش السوري يصعد هجماته على المعارضة المعتدلة، وإخفاق أميركا في تذليل هذه
المشكلات يطيح بعلاقاتها بالحلفاء في سورية والدول السنية التي انضمت إلى الحملة
على «الدولة الإسلامية»، ويرى محللون أميركيون أن واقع الحال مرير، فإلحاق الهزيمة
بـ «داعش» في سورية يقتضي أكثر من إلقاء بضع قنابل عليها ودعم مجموعة صغيرة معتدلة
دربتها أميركا، يقتضي تدخل قوات برية أميركية أو التحالف مع بشار الأسد المدعوم من
إيران وروسيا، وفي وسع أوباما اللجوء الى خيار ثالث وهو التراجع والعودة إلى
استراتيجية الاحتواء والتقويض في العراق وتفادي التزام كبير في
سورية.