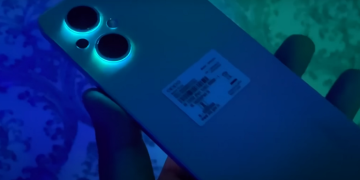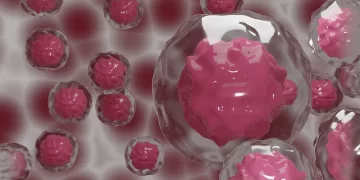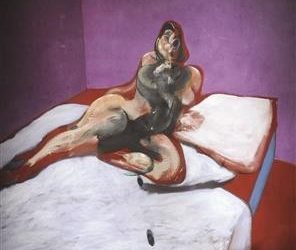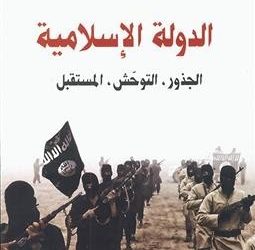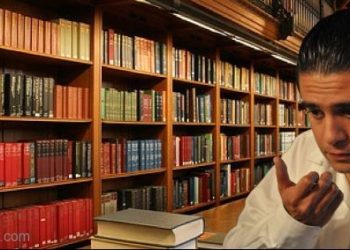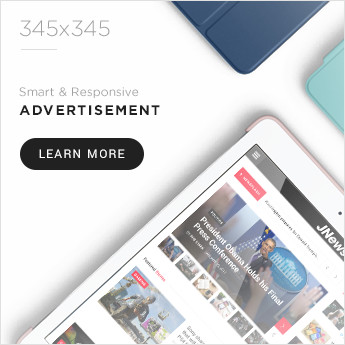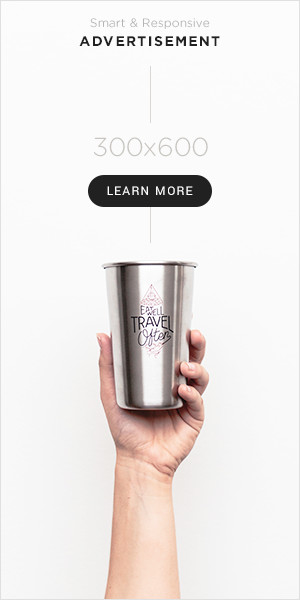بالتأكيد لا تشكل هذه الأسماء الثلاثة، كل الجيل الشعري الجديد الذي بدأ يخط حضوره في المشهد الشعري اللبناني الحديث، إذ ثمة آخرون يتكاملون معهم، لكن شاءت الصدف أن يلبي هؤلاء الدعوة التي وجهت إليهم بينما اعتذر آخرون. في أي حال، هي مناسبة للحديث عن هواجس ومناخات الكتابة التي يحاولون التقاطها في شعرهم، وبالتالي، مناسبة للاطلالة على ثلاث تجارب، قد تكون الانطلاق في محاولة قراءة هذا الجيل بكل ما يحمل من هواجس أدبية وفكرية وحياتية.
^ عباس بيضون: من الجيد أن نلتقي بثلاثة شعراء من الجيل الأجد (كما يقول عبد العزيز المقالح)، ربما أن جيلينا لم يبحثا عن بعضهما بعضا وكأن ثمة ركودا بيننا قد نقول إنه ركود الثقافة بأكملها. عندما يطلع المرء على أشعاركم – وما اطلعنا عليه هو قليل – يكتشف أن ثمة عودة إلى الشعر الموزون، إلى شعر التفعيلة، وذلك على خلاف مع الجيل الذي سبقكم الذي كان جيل «نثر». من هنا يتساءل المرء عن علاقتكم المباشرة «بأي جيل». أحيانا يُخيل إلينا أن الجيل الذي تتقاطعون معه – وخاصة شعراء التفعيلة – هو جيل ما سمي «شعراء الجنوب». لذلك أول سؤال يتبادر إلى الذهن: ما هي علاقتكم بالأجيال التي سبقكتم؟
^ محمد ناصر الدين: حين بدأنا مشروعنا الشعري في بداياتنا، كنّا نبحث عن «مثال» لنا، عن «صنم»، وهي أصنام موجودة. كان لدي عدة «أصنام» هي محمد علي شمس الدين، محمد الماغوط، أدونيس.. كان ذلك قبل ذهابي إلى فرنسا واحتكاكي بالشعر الفرنسي. قبل هذه الفترة كنت أنشر قصائدي في نهار الشباب وهي كانت «فوتوكوبي» عن هؤلاء الشعراء…
^ عباس: هل وجدت شعراء من جيلك؟
^ محمد: نعم إنهم موجودون، هناك مجموعة: فيديل سبيتي، سمر دياب، جلال الأحمدي، محمد بنميلود (المغرب)… ثمة مجموعة كبيرة. في أي حال، أنا الآن لم أعد أكتب على الوزن، كأن ثمة قطيعة حدثت معه. أنحاز اليوم إلى قصيدة النثر أكثر.
^ باسل الزين: بداية، علاقتي بشعراء الجيل القديم كان بشقين: من يكتب قصيدة التفعيلة ومن يكتب قصيدة النثر. وبالتالي، وتعقيبا على ما قاله محمد، وجدت الصنم في داخلي قبل أن ألاقيه في الخارج. بمرحلة ما، ارتبطت التفعيلة والشعر الكلاسيكي بالقضايا القومية. بدأت كتابة الشعر الكلاسيكي والتفعيلة وكان كل خروج عليهما يعتبر خروجاً على محيطي وعلى هوية اللغة العربية نفسها، لغاية أن استوقفتني بعض التجارب الكبرى مثل الماغوط وأنسي الحاج تحديدا. من هنا استرحت (عن الكتابة) فترة سنتين أو ثلاث وقمت بقطيعة مع ما أسميتهم شعراء الجنوب، وباشرت بكتابة القصيدة الأولى متحررا من كل هذه القيود، حيث استطعت اكتشاف ما يمكن أن تقدمه قصيدة النثر. لا أريد أن أكون قاسيا في حكمي لكني أظن أن شعراء التفعيلة اليوم قد وصلوا إلى مأزق ما، أعتقد أن قصيدة النثر قادرة على الخروج منه.
^ عباس: لكن هناك أيضا في الجيل القديم شعراء نثر؟
^ محمد: بالتأكيد. برأيي ما استطاع أن يصل إليه الماغوط، لم يستطع أي شاعر عربي أن يصل إليه، مع احترامي للجميع.. ثمة جملة لمحمود درويش قالها في تأبين الماغوط: لا يمكن لنا أن نكون مع الماغوط وأن نقف في وجه قصيدة النثر.
^ مهدي منصور: حين نتحدث عن العلاقة بين الأجيال نكون نتحدث عندها عن طرفين. لأن الشعر كان مقسوما على نفسه، أتخيله كشاحنة كبيرة تشترك في سباق للفورمولا واحد، حين «تلف الكوع» تجد أن الجمهور بأكمله يدير رأسه معها يمينا ويسارا، وهنا من هو ضد ومن هو مع.. نلاحظ أن لدى «شعراء الجنوب» نسقاً كتابياً – التفعيلة – وكان وقتها، برأيهم، آيلاً إلى الانقراض، فكانوا يفتشون على أبناء يتبنون هذه الراية ويحملونها. في حين أن الذي كان يكتب قصيدة نثر، لم يكن لديه أب، كان يتيما، لكن كان لديه أبناء يتكئ عليهم. هي علاقة جدلية بين الاثنين. لقد تقاسمنا العلاقة مع الجيل الذي مرّ قبلنا: نحن من كتب التفعيلة كانت علاقتنا المباشرة بـ»شعراء الجنوب» والذي كان يكتب قصيدة نثر – مثل مازن معروف وغسان جواد وناظم السيد – فذهبوا أكثر إلى عباس بيضون وأمجد ناصر واسكندر حبش ويحيى جابر، مع الفارق بالطبع من حيث العمر والتجربة.
^ اسكندر حبش: أريد أن أقاطعكم وأعقب على كلام مهدي تحديدا: إن أردنا أن نبقى في تسمية «شعراء الجنوب» من دون أن ننظر ونرى إلى التطور الذي أصاب قصيدة هؤلاء الشعراء فبرأيي أن ذلك كارثة ومصيبة. صحيح أن هناك شعراء عديدين بقوا عند التفعيلة ولم يخرجوا منها، كأسلوب كتابي، لكن لنأخذ أي شاعر من هؤلاء نجد أن من كتب، على سبيل المثال، «الرحيل إلى شمس يثرب» يبدو مختلفا عن الذي كتب «مرثية الغبار» أو «فراشات لابتسامة بوذا». إنه الشاعر نفسه، لنقل بقي على الوزن (التفعيلة) لكن علينا أن نفصل بين أمرين: الوزن والمضمون. هناك تطور كبير حدث في مضمون هذه القصيدة التفعيلية. وحتى هناك الكثير من المفردات التي تغيرت. ما أريد قوله: يجب أيضا إعطاء الحق لهؤلاء الشعراء.
تكوين ثقافي
^ عباس: لندخل إلى أمر آخر: التكوين الشخصي والثقافي. اثنان منكم هما في الواقع علميان وهذا أمر غير موجود أبدا في الجيل السابق.
^ اسكندر: هناك جودت فخر الدين الذي درّس الفيزياء.
^ عباس: هل تجدون أنكم تملكون تكوينا مختلفا، تكوينا ثقافيا وشخصيا؟
^ محمد: أعتقد أننا قمنا جميعا بتمرين هويتنا، كما نجده عند أمين معلوف في كتابه «الهويات القاتلة». أي كم أنتمي أنا إلى الثقافة العربية وإلى الثقافة الإسلامية وكم أنتمي إلى شيعيتي في مكان ما وإلى لبنانيتي وكم أنا عالمي. أعتقد أن الهوية طبقات والنص بدوره مركب من طبقات. فأنا حين أقرأ الفلسفة وحين أقرأ الفيزياء أو التاريخ، كل ذلك يشكل بطانة للقصيدة. بالتأكيد ساهم تكويني في ذلك. ذهبت إلى فرنسا بذهنية لبنانية، واستمر الأمر معي لمدة سنتين كي أخرج من هذا الوضع: كنت أتناول طعاما لبنانيا وأفكر لبنانيا وأذهب إلى «الفناك» لأشتري كتبا لبنانية مترجمة. بعد سنتين استطعت الذهاب إلى الآخر، عندها رأيت باريس مدينة متاحف ومسرح. علاقتي باللغة الفرنسية هي التي أوصلتني إلى الشعر.
^ عباس: مَنْ الشعراء الفرنسيون الذين يعنون لك؟
^ محمد: يعني لي رينيه شار.. أقرأ أيضا إيف بونفوا وجاكوتيه وبول فاليري، وأحب تنظيرات مالارميه في الشعر وعلاقة الشعر بالرياضيات والفلك مثلا.
^ عباس: لكن الذي يقرأك لا يرى أثر هؤلاء في شعرك الذي يذكر بجاك بريفير وغيوفيك أكثر مما يذكر بهؤلاء.
^ باسل: أعتقد أنني ارتكبت خطأ في البداية بعدم إقامة علاقة بالشعر العالمي، وهذا ما استدركته منذ خمس سنوات. ربما كانت القضايا القومية ونهضة اللغة العربية لا تزال على عاتقنا.
^ عباس: تتحدث عن القضايا القومية، من أي اتجاه؟
^ باسل: من اتجاه أننا ونحن صغار كنا نعتبر أن الشعر هو للمحافظة على اللغة العربية وإعادة الاعتبار لها.
^ عباس: من أين أتى ذلك؟
^ باسل: من البيئة المنزلية بداية، ومن ثم من القراءات.
^ عباس: هل تقصد القوميين الاجتماعيين؟
^ باسل: البعثيون تحديدا، من ثم تكتشف ان القصيدة لا تحمل قصيدة معينة بذاتها على الاطلاق. كلما انفتحت على تجارب شعرية عالمية، تشعر بأننا ما زلنا بعيدين عن تلك التجارب التي يشاركك فيها انسان آخر في مكان مختلف من على هذه الأرض. تكتشف عندها أنه يجب عليك أن تخرج من هويتك الضيقة إلى هوية أكبر كي تحقق هوية الشعر الكلية لا هوية الشعر الجزئية.
^ مهدي: المرحلة الأولى، شئنا أم أبينا، الذي بنى النص قبل جيلين، كان على علاقة حميمة بالأرض المفقودة والفقد هو رديف الشعر بمعنى من المعاني. من هنا أجد أن تركيبنا مختلف وهمومنا مختلفة. نحن جيل نشبه «الانترنت» أكثر، «العولمة» أكثر…
^ محمد: كما يقول ميشال سير نحن جيل «السبابة» (الاصبع).
^ مهدي: فعلا نحن جيل «الأيباد»، تركيبنا مختلف وأوافق على هذا الكلام.. لذلك اتجهت نحو الفيزياء لأني وجدت فيها بعدا آخر، لأني كشاعر ألاحظ الظواهر الطبيعية وأحللها وتدخل في نسيج كتابة القصيدة، بينما كفيزيائي تشاهدها وتقوننها في مكان ما. اعتقد أننا جميعا، الحاضرين هنا، والغائبين عن هذه الجلسة، رياضيون بشكل من الأشكال، إذ كما يقول أيلر: إن أردت أن تكون شاعرا فعليك أن تكون شاعرا وبعض رياضي». عليك أن تملك هذه البنية بشكل أو بآخر. أنا بدأت ضوءا ثم تكثفت إلى نجم أسود، باعتبار أن برنامج «المميزون» أضاء علي وكنت لا أزال فرخا، إذ كنت بعد تلميذا ثانويا ولم أقرأ الشعر. أعلني البرنامج شاعرا وصار علي أن أصدر الكتب وألبي الدعوات وأنا لا شيء بعد، إذ كنت خارجا لتوي من كتاب القراءة. كل شخص ضمن هذا الجيل له تركيبه الخاص كما ضمن الأجيال السابقة أيضا.
^ اسكندر: أريد أن أعود إلى فكرة طرحت حول الشعر الأجنبي. بأي معنى أولا تعتبرون أن الشعر العربي الذي قرأتموه في السابق لم يكن «واصلا» إلى هذه الدرجة. لمَ؟ أين المشكلة؟ من وجهة نظر شخصية، و»عن جد»، وبعيدا عن كل الترجمات التي قمت بها وأقوم بها للشعر الأجنبي، أميل منذ سنوات إلى الشعر الكلاسيكي العربي أكثر فأكثر…
^ عباس: لا يمكن لنا أن نكتب بعد مثل المتنبي، لكن لا يمكننا أن نقول إن المتنبي لا يقارن بالشعراء الجدد.
^ اسكندر: قال عباس جملة وأريد العودة إليها: من يقرأ شعركم يجد أن الشعر الأجنبي الجديد غير حاضر البتة.. وأقصد الشعر الذي كتب هناك من الثمانينيات لغاية الآن. لا تزال اللغة الشعرية عندكم عربية وأقصد أننا كلنا نخرج من المكان عينه حتى المراجع الأجنبية تشكل لنا كلنا الخلفية عينها.
^ محمد: لا أشعر بأن التحدي يكمن في أن هذا شعر عربي أو أجنبي، أو هو شعر كلاسيكي أو رومنسي أو قصيدة نثر.. السؤال يطرح عادة على الاتجاهات الشعرية، ما الذي بقي وما الذي أفل. هل استنفدنا الرومنسية والكلاسيكية في الأدب العربي والمدارس في الشعر والفن أم أن الشعر الرومنسي قضى على الشعر الكلاسيكي أم أن قصيدة النثر قضت على الكلاسيك؟ لا أعرف. هل بإمكاننا أن ننسف كل هذه النظريات وأن تبدأ الكتابة من نقطة الصفر مثلما يقول بارت؟ هذا سؤال. العرب يحبون القافية. وكما قال أبو حيان التوحيدي: «النظم أدل على الطبيعة لأن النظم من حيّز التركيب، والنثر أدل على الأقل لأن النثر من حيز البساطة والوزن معشوق بالطبيعة والحس». أعتقد أننا محكومون بالنسق القرآني والايقاع. النقاش كما أراه: هل الشعر هو السفر بين الصوت والمعنى كما قال فاليري أم ان عليه أن يحمل أمرا آخر؟ برأيي أن الشعر يتغذى من هذا القلق وهذا الدخان والدوار والضبابية التي نجدها في داخله. النقاش ليس في قصيدة نثر أو قصيدة كلاسيكية.
السياسة والخارج
^ عباس: أريد أن أسأل سؤالا «مبتذلا». كان الشعراء الذين أتوا قبلكم يعتبرون أن لديهم قضية وأن الشعر هو ليس فقط يتحدث عن الذات بل له علاقة بالخارج وله علاقة بالسياسة بشكل عام. هل تشعرون بأن لديكم الفكرة ذاتها؟ لماذا يظهر أنكم تتحاشون الدخول في موضوع سياسي أو خارجي؟
^ باسل: أريد أن استعيد هنا كلمة لميخائيل نعيمة، يبدو فيها أنه قطع أشواطا بعيدة، حين يقول: «هات الكلمة البعيدة البعيدة». لا يهمني أي شكل تتخذه القصيدة.. من هذا المنطلق – وأتحدث عن نفسي – لا يمكن للشعر أن ينخرط في قضايا سياسية وأن يأتي «بالكلمة البعيدة البعيدة». كل القصائد التي كتبت عن الجنوب، أصبحت ساقطة ولا قيمة لها. يجب أن نبحث عن قصيدة خالدة. ما أبحث عنه هو قصيدة الرؤيا، التي تتخطى الزمان والمكان. لا أبالغ إن قلت إن ما يحققه الفيزيائي عن طريق التأمل وقوننة العلوم يمكن للشاعر برحلة رؤيوية أن يعثر على هذا الأمر. أعتقد أن القضايا السياسية ستنتهي بعد سنين، لذلك أعتقد أن الشعر يفقد الكثير من قيمته إن هبط إلى المستوى الواقعي والمبتذل اليومي. أعتقد أن الشعر أبعد من ذلك بكثير.
^ عباس: لكن الشعر ابن لحظته أيضا وليس فقط كلاما مع المستقبل.
^ باسل: القصيدة الرؤيوية كما افهمها هي القصيدة الصالحة في هذا العصر ولكل زمان ومكان.
^ عباس: ماذا تعني بكلمة رؤية؟
^ باسل: هي قصيدة الكشف التي تغوص في عمق النفس الإنسانية تستبطن أشياء في عمق هذه النفس صالحة لكل الأجيال.
^ مهدي: لا أعتقد أنك تقصد بالسياسة السياسة اللبنانية وسياسة المذاهب والطوائف، بل السياسة هي الرؤية العامة التي نشأت منها مدارس فكرية. أنا شخصيا مع أن يتطرق الشعر، بشكل من الأشكال، إلى حالة سياسية ولا سيّما أن الشعر يتأثر بها وهو أسير لها. في كتابي الذي سيصدر قريبا، هناك أسئلة وقلق. الأسئلة الكبرى التي هي نهاية هذا العالم. واحدة من أكبر السياسات المتبعة اليوم في العالم هي سياسة بيئية، أي هل هذا البيت الوحيد الصالح للسكن في هذا العالم هو كوكبنا، ولم نتمكن بعد من إيجاد مكان آخر نذهب إليه. من هنا أطرح أسئلتي. بالطبع لا أتحدث عن ثاني أوكسيد الكربون بل أطرح أفكارا عن علاقتي بالأرض ككل. وأعتقد أن هذه الأسئلة سياسية.
النقطة الثانية، لا يهمني كيف يكتب هذا النص، أنا مؤمن بأن النص خارج القوالب، وسأردد ذلك مرة أخرى: دائما نهرب من الكلاسيكيات العمودية والجاهزة إلى كلاسيكيات نثرية جاهزة. حداثيو اليوم هم كلاسيكيو الغد، إن لم ينتبهوا إلى التردد والتكرار في عملهم. أنا مع نص مختلف بعيدا عن شكله، لأن هذه الأشياء الكاتدرائية من الخارج باردة جدا من الداخل أكانت عمودية أو غير عمودية. من هنا المهم ماذا نقول وكيف نقول. يجب الا نحكم على النص من حيث شكله الخارجي.
^ اسكندر: لماذا تعتبر أن الشعر المقاوم هو فقط الشعر الذي يحتوي على هذا الخطاب المباشر؟ شعر ريتسوس هو شعر مقاوم على سبيل المثال. ورينيه شار، نصف شعره شعر مقاوم. أصلا أنا أعتبر أن كل كتابة هي عمل مقاوم بمعنى من المعاني. أعتقد أن المشكلة الفعلية هي ماذا نريد من القصيدة وكيف نقولها.
^ محمد: أعتقد أن المستقبل نص مفتوح متعدد الأصوات، علينا أن نلتقط فيه «خيط أريان» الذي سيخرجني من الأنا، من المحلية، من التهويمات النفسية، والأشياء الصغيرة إلى لغة عالمية. لم تعد هناك حصرية للثقافة والمعرفة، أي انسان اليوم يمكن أن يجد «متحفا» على هاتفه، كل الجرائد في العالم موجودة عليه. من هنا امتلاك المعلومة لم يعد شيئا كبيرا بل ما هي اللغة التي يفهمها الجميع؟
^ مهدي: لا بد للشعر من أن يفتش عن عوالم أخرى لكن شرط ألا يتجاهل العوالم التي يعيش فيها. على العكس، «الآن وهنا» على طريقة نيتشه. مدى صدقية «الآن وهنا» هو ما يجعلها تعيش أكثر بشكل من الأشكال.
عباس بيضون وإسكندر حبش
رابط المقال من جريدة السفير اللبنانية: