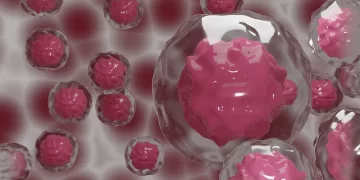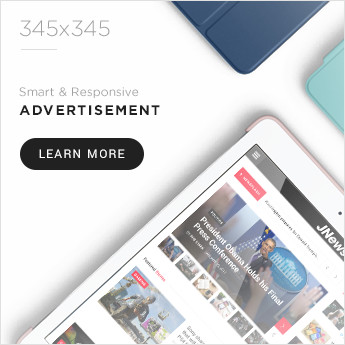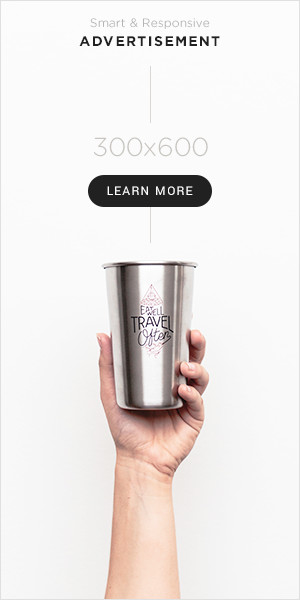صدى العرب: تتواصل “الحالات” الأمنية في لبنان تحمل في طياتها الكثير من اهمال الدولة وتشتيتها حتى وصل الامر الى مرحلة لا تُطاق، فبالرغم من “عنتريات الداخلية” الى ان زعران الأزقة مازالوا يعبثون بالأمن ضاربين عرض الحائط القانون مرددين ” ايه مرحبا دولة”..
في المتابعات لملف الأمن في الضاحية الجنوبية نعرض لكم اليوم أسلوب جديد للأسف من البلطجية و”التشليح” الذي يعتمده البعض باسم الدولة برواية شاهد عيان وبتأكيد من سكان المنطقة بأن هذه الأمور تتكرر باستمرار سعياً وراء “الرشوة”.
الزمان: الأربعاء 09.04.2014 – الساعة التاسعة الا عشر دقائق
المكان: مدخل الضاحية الجنوبية – الشويفات
لنَخُنْ وصايا ذوينا!
كعادتي، كنت أسلك الطّريق الروتينيّة بين المدرستين
اللتين أخوض حاليًا غمار التعليم بهما. كان وقع صوت “حليم” عذبًا هذا
اليوم، وكانت مشكلة تحديث العقل العربي في مجالي التربية والتعليم تقض مضجعي، إذ
كيف أقص على تلامذتي سيرة نص تربوي أرجأته كفاية لكي لا أقع في فخ السؤال التقليدي
الذي خبرته طوال أعوام: من يحاسب من عجبي؟
لم أكن قد ولجت بعد إحدى المنعطفات المذيلة بعدد لا حصر
له من الحُفَر، حينما استوقفني من بعيد منظر لأحد رجال الأمن (أو العابثين بالأمن
سيّان ربّما) وهو ينتحي زاوية مبهمة على مشارف منعطف آخر يطلّ منها غداة إبصاره
سيارات بعينها يكون قد رصدها له عابث أمنيّ آخر انتصب كشارة مبهمة في الخط الوهمي
الفاصل بين خطي السير، ليرمي الأول بأثقال جسده أمامها ملوحًا بيديه قف وانتحِ
ركنًا جانبيًا.
بطبيعة الحال، المشهد غير مألوف، فلو كنا أمام حاجز مركزي
لوجب على رجال الأمن اتخاذ وضعية الحاجز التقليدي، كدأب جميع الحواجز المتعارف
عليها، بخاصة وأن المكان الذي تم رصد السيارات فيه لا مجال فيه للسائقين من
التنصل.
عند ذلك الحد، شرعت أخفف وطأة سير مركبتي الآلية، وإذا
به يلوح لي بكلتا يديه مشيرًا إلى ضرورة انتحائي يمينًا.
توقفت، وقد ساورتني شكوك بشأن ماهية هذا الحاجز، فما كان
منه إلا أن اقترب بخطى متسارعة وصافحني بود لم أعرفه من قبل، قائلاً: “جميل
هذا النوع من السيارات”، حاولت استباق الأمور، فأخرجت من جيب محفظتي
“دفتر السيارة” و”رخصة القيادة” محاولاً دفعهما باتجاهه، لكن
اكتفى بابتسامة صغيرة معقبًا: “هيدي السيارة عاملا ميكانيك؟ إذا ما عاملا قلي
تنزبط الوضع”، فما كان مني إلا أن دسست في يديه أوراق السيارة متكاملة، حتى
إذا ما ألفاها كاملة، قطّب حاجبيه، ودسها بقوة بين يدي دون أن يتكلف عناء إعادتها
إلى المظروف الواسع الخاص بها، مشيرًا بيده، ومُعقبًا: “ايه الله معك”.
إذ ذاك، عبرت خط سيري مستقيمًا، وتوقفت عند أحد الأفران
وساءلته عن ماهية هذا الحاجز، فأجابني من فوره: “هيدا مش حاجز، هول كل كم يوم
الصبح بيعملوا هيك تيقبضوا”.
عند هذا الحد، أعد طي حسابات والدي الارتكاسية، وشرعت في
السير في الاتجاه المقابل، وعلى مقربة من الحاجز الذي ياسرني استخدمت هاتفي
المحمول، والتقطت صورة بالجرم المشهود.
حاولت متابعة سيري بشكل طبيعي، لكنّ القويّ الأمني صرخ
بي : “قف”، فما كان مني إلا أن أطلقت العنان لمركبتي الآلية، على وقع
صوته وهو يتصاعد بوتيرة عالية: “عل كل حال عرفنا السيارة، وين…”،
وانقطع حبل الصوت نهائيًا.
سلكت دربًا طويلة، قبل أن أهاتف والدي الذي علمني طوال
سنواتي الثلاثين أن أكف عن مطاردة الفساد لأنني لا أستطيع بمفردي أن أبدل مصير بلد
بأكمله، هاتفت والدي الذي كال لي الهجاء، قائلاً:” بوسع هذا القويّ الأمني أن
يقلب حياتك رأسًا على عقب، أنت كائن يبحث عن المشاكل، وتعتلج في صدرك مشاعر
إيجابية لكنها ليست لهذا الزمن”.
عند هذا الحد، قطعت دابر الصمت الذي امتد سنوات طوالاً،
وعقبت قائلاً: “ينبغي عليّ أن أحاور طلابي اليوم وأطلب إليهم أن يغضوا طرفهم
عن كل أشكال الفساد، وأن يخونوا وصايا التربية المدنية والوطنية، وينبغي عليّ أن
أعلم ولدي الذي لم يبلغ شهره السادس بعد أن يتقوقع على نفسه، ويُطأطئ رأسه غداة كل
انكسار لأنّه لا يملك سلطة قول :”لا”، في الحد الأدنى من إنسانيته
المرتجاة. لكن عذرًا والدي، سأعلم طفلي رسم صورة أبيه كما كان يتمناها، وأولى
الوصايا أن يخون وصايا جدّه”.
قد يصدق تخمين والدي، لكن نجاحي يكمن في كسر حاجز الخوف
ولو للمرة الأولى، مع العلم أنّ نتاج هذا الكسر لن ينعكس إيجابًا على أي مستوى
تغييريّ، سوى كتابة حروف هذه المقالة.
أ. باسل بديع الزين
للتواصل مع الكاتب عبر الفايسبوك:
https://www.facebook.com/bassel.elzein?fref=ts